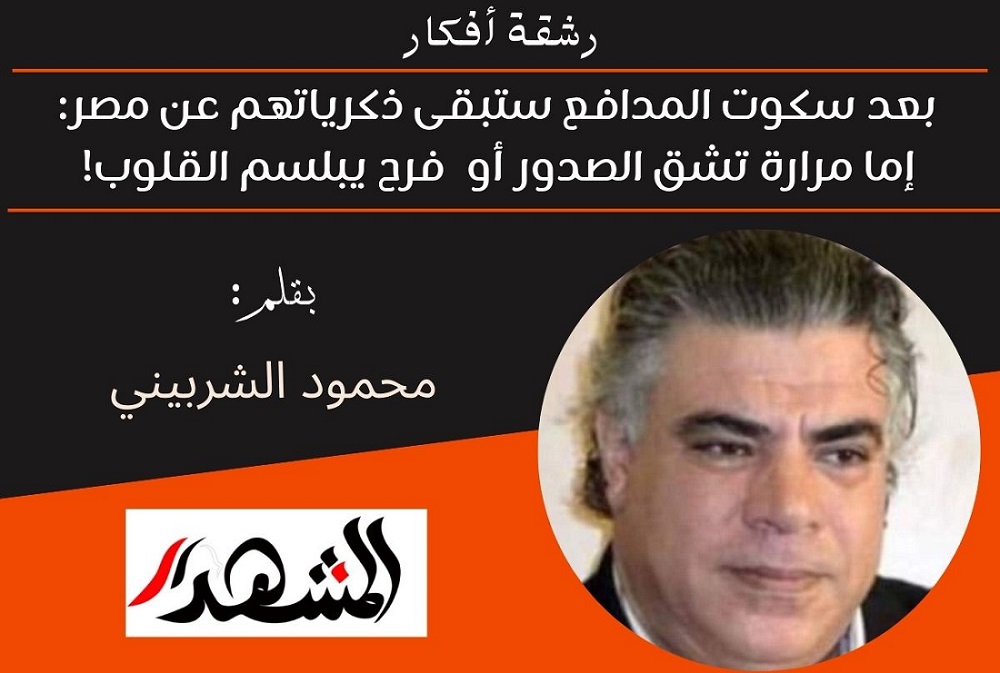*إفاقة متأخرة .. قد تستوجب اعتذارًا علنيًا!
لقد أفقت متأخرًا جدًا على كارثة!
نعم .. كارثة حقيقية، ليس الأمر مجرد تهويمات أو ضرب من الإثارة ، وإنما هي إفاقة متأخرة، لا أعرف إن كانت تتطلب اعتذارا عامًا أم تتطلب شيئًا آخر ينبغي التفكير فيه؟! . - لا اعرف كم من المرات قلت فيها - ونحن في نقاش - إن "الحوار" يحل كل شيء، ويمكن أن يقودنا إلى دروب عملية لمواجهة أي مشكلات وأزمات حياتية! كانت العبارة تتكون في عقلي وتجري على لساني وكأنها عصا موسى السحرية! سنوات طويلة مضت على اقتناعي بأن كل شيء يمكن حله بالحوار، مادام الناس قد اجتمعوا على مائدته!
أفقت من أوهامي وخيالاتي، وتجلت لي عصا موسى الشهيرة وكأنها السحر الذي انقلب على الساحر، فحتى أعتى المؤمنين بالديمقراطية والحرية والإيمان بأنه لانجاة للمجتمعات من دون تبادل الآراء، وأن المقولة الخالدة لفولتير "مستعد أن أدفع حياتي ثمنًا لحقك في التعبير عن رأيك".. مجرد جملة نتأنق بوضعها كما نضع زهرة في عروة الجاكيت! نكتبها في مقالاتنا ويدبجها الكتاب والمفكرون في كتبهم ودراساتهم . يقول الناس ما لا يؤمنون به .. وما ليسوا مستعدين لتحمل تبعاته. (إلا من رحم ربي طبعًا) يسقط في هذا الفخ العجيب الغالبية العظمى: البشر العاديون، والمسؤولون والساسة والعلماء والمفكرون والأساتذة والمبدعون الخ.
حالة الانفصام مابين الكلمة والفعل وباء متفشي، بلوره تعبيرًا منذ زمن بعيد د. يوسف إدريس؟ ( يثور السؤال هنا: هل كان يوسف ملتزمًا بألا يسقط في هذا الفخ ، أم أنه كان "الإمام" في هذا الميدان؟ عموما ليس هو موضوعنا، وإن كانت تناقضات المبدعين أمرٌ معروف)! تذكرت هذا أمس وأنا أجلس إلى كاتب وأستاذ إعلام وأكاديمي معروف، وقد تعرض لأزمة عاتية عصفت بحياته، ولاتزال تعصف. تذكرت أنني عندما شغلت بوضعه المزري وقد نُكِل به وسجن أيامًا وتعرض للتشويه وعُرُض على مجالس التأديب وصودر حقه في الحياة والعيش والكرامة الإنسانية ، سألت بعضا من ذوي الرأي والفكر عن حدود فهمهم لأزمته العنيفة مع السلطة ومع الجامعة، منوها بما جري له من سجن وتحويل إلى مجالس تأديب بالجملة (كثير منها - على قِدَمه - لايزال ساريًا حتى اليوم، وربما تفتح الأدراج حين تحين لحظة أخرى إذا فكرت أصوات مدفعيته الثقيلة الساكتة الآن مجرد تفكير في الإنطلاق!) عن موقفهم من قضيته، فوجئت أن الحوار عقيم.. لايليق بمن أسألهم! انقلب لردود شخصانية تدور حول علاقة بين أستاذ ورئيسه في الجامعة! لم ينتصر رأي من سألتهم إلى حق الأستاذ في العمل والحرية واحترام حقه الإنساني في التعبير والترقي! لم يتطرق الحوار مع عقول مفكرة إلى قضية الأستاذ الأساسية وهي حقه في الحرية والتعبير! تحول الموضوع إلى الحديث عن شخصية الأستاذ ورئيس الجامعة! لم يتوقف أحد عند إيقاف الأستاذ عن العمل ثلاث شهور، ثم تجديد الإيقاف ثلاث أخرى، ثم ثلاث ثالثة! ٩ شهور كاملة توقفت فيها حياته، فلم يتقاض مرتبه - تخيلوا حدوث ذلك وهو يعول أسرته!- ولا يمارس عمله ، ويعيش وحيدًا معزولا بل ويكاد يموت وهو على قيد الحياة!
مهم أن أتذكر ماحدث لرجل يعد عالمًا أو خبيرًا في تخصصه، لكن القضية هنا ليست الأستاذ، وإنما كيف يعمل عقل المجتمع؟ ما الذي يؤمن به وما الذي يدافع عنه؟ (سطور ثقيلة الظل أليس كذلك؟.. لا بأس.. كلٌ في فلك يسبحون!) حين يتحول عقل المجتمع من خاصة الخاصة من العام حيث الاهتمام الأشد بالحقوق والحريات العامة إلى منطقة أخرى تستلب فيها هذه الحقوق ولا يطالب بها أحد، او يتوقف عندها أحد، لأن طرفيها عليهما ملاحظات أو لهما مآرب شخصية أو حياتية، وتضيع قضايا أساسية - وهي الحقوق والحريات - فإنها تصبح كارثة! فما الذي أبقينا عليه للمواطنين العاديين، الذين ينشغلون مثلًا بطلاق إعلامية شهيرة من إعلامي أشهر، قرر أن يطلقها ليتزوج صديقتها؟
ما هذا الجنون الذي يمارسه الناس؟ ما هذه الشهرة البشعة التي يمكنها أن تمسخ مجتمعًا كاملاً؟ هل هؤلاء يستحقون أو يدركون مدى أهمية ذلك الحلم المثالي الذي كنت أحلم به، او التهاويم التي كنت أعتنقها وأبشر وأدعو اليها وأعتبرها عصا موسى السحرية؟ ماهذا الجنون المطبق الذي يجعل الناس تعيش هذا التناقض الحاد بين ماتؤمن به وتدعو إليه وما تمارسه من "أفكار" إذا جاز وصف التفكير بأنه ممارسة عقلية!
يبدو لي أن الحوار كان زمان! وهذا ليس زمانه فعلا! فالناس لم يعودوا هم الناس.. لو أنني كنت أسأل زكي نجيب محمود أو محمود العالم أو لويس عوض عما يحدث بين الأستاذ ورئيس الجامعة الذي كان يحلم بالوزارة ونكل بصاحبنا بشكل لامثيل له، وهو يعتقد أنه يقدم أوراق اعتماده للسلطة من أجل مستقبل سياسي، إما أن يكون فيه وزيرا للثقافة أو وزيرًا للأوقاف.. لكان الأمر مختلفًا.. فسوف يسألون عن القضايا والمضامين التي كان الأستاذ يدعو إليها والحقوق والحريات التي كان ينشدها، والأفكار التي يدعو إليها ولن ينشغلوا بمثل ما انشغل به من سألتهم من المفكرين!
العلماء غيبوا أو غابوا.. بالرحيل.. بالعزلة وفقدان القيمة.. بالهجرة.. بالسجن! تغيرت الأمور وجرت مياه كثيرة عطنة تحت الجسور، وتأثرت مجتمعات - من بينها مجتمعنا - بفعل وتأثير ما أسماه آلان دونو نظام التفاهة! افتقدت البوصلة لكن لم تفقد الدفوف والطبلة. غاب زمان الحكماء وطرح الآراء العبقرية. ومن أين سيأتي ذلك والتعليم مسطح وفاقد لغاياته وأهدافه.. والمسرح مغلق بالضبة والمفتاح، والسينما تكافح لعرض فيلم واحد خارج النص المألوف.. والغناء الذي كان يمسك بالأسماع ويأخذ بالألباب توقف بعد صوت ثومه وشادية ووردة والعندليب، والسائد الآن "آه لو لعبت يازهر" ترقص عليها جميلات المجتمع وكريماته ونخبته!
حوار مجتمعي! كان زمان وجبر. اعتصمنا بهذه الفكرة سنوات.. كررنا المطلب منذ زمن الرئيس عبد الناصر، وقت أن كانت العقول بخير والثقافة عطر يفوح في المجتمع. عهد العقول الغفيرة، رغم أنها كانت حبيسة بين جدران أربعة، وكررنا المطالب زمن السادات، الذي كان يتصور أنه مبتدًا كل شيء ومنتهاه. وأن مثل هذا الحوار يكون بينه وبيننا كرئيس ومرؤوسين، فإن اقترح أحد فكرة رد عليه بقوله "انت يا إبني لاتحترم كبير العيلة، ولا تتحلى بأخلاق القرية" ويخترع له قانونا لحماية القيم من العيب! كررناها ثالثًا أيام مبارك فكان عمليًا يعتبرها دعابة ومزاحًا ثقيلًا، وبمعني أدق يقول مثلما ورد عنه في الأثر المباركي "خليهم يتسلوا"!
في هذه العصور وقبل أن تشيخ السلطة في مقاعدها، ويحدث التجريف العنيف في المجتمع كما قال الأستاذ هيكل، كانت مصر تقرأ وتفكر وتكتب وتدرس وتبدع وتتحاور مع بعضها البعض، في مراكز الأبحاث (مغلقة الآن) وكانت تموج بالأفكار والدراسات والرؤي، وسيمينارات الجامعات (ماتت أو قبرت) بكل ما كانت تقدمه من عصف فكري يشع نورا في العقول ويمد المجتمع بطاقة حيوية مذهلة!
لقد سقطنا في الفخ بجدارة! أتذكرون نتاج السنوات العجاف التي تجمد فيها كل شيء في مصر حتى سقطت مصر كتفاحة معطوبة في أيدي الإخوان! هل أذكركم بذلك المؤتمر العلني أو الفعل الفاضح عبر التليفزيون، عندما قررت باكينام الشرقاوي عقد اجتماع برئاسة مرسي من نوع "تستيف" الأوراق لمواجهة كارثة سد إثيوبيا! أتذكرون مالذي قاله مرسي عندما علم ان المؤتمر مذاع على الهواء، وماذا اقترح الأخ أيمن نور في هذا عن إرسال طياراتنا المقاتلة لتحلق فوق أديس أبابا "كاموفلاج" كده وكده يعني!! (البقية غدًا)
------------------------------
بقلم: محمود الشربيني